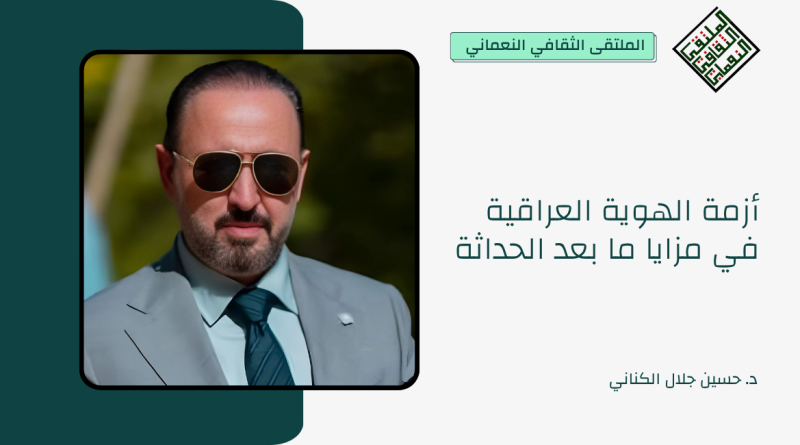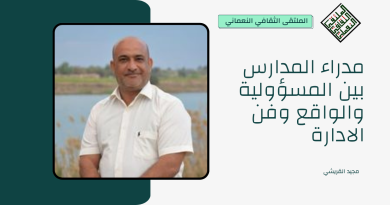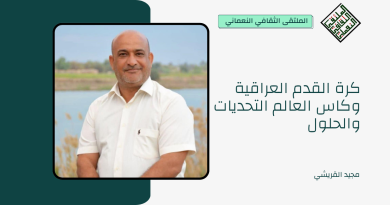أزمة الهوية العراقية في مزايا ما بعد الحداثة
د. حسين جلال الكناني
تشهد الهوية العراقية في العقود الأخيرة تحولات جذرية تعكس تأثيرات ما بعد الحداثة على المجتمعات العربية والإسلامية، حيث تتفكك الأسس التقليدية للانتماء الجماعي لتحل محلها هويات سائلة ومتشظية تتماشى مع روح العصر الرقمي المعولم. وفي هذا السياق، يمكن فهم الأزمة الهوياتية العراقية كنموذج معبر عن التحديات التي تواجهها المجتمعات التي تحاول الحفاظ على خصوصيتها الثقافية في ظل موجات التغيير ما بعد الحداثية.
إن ما يميز الحالة العراقية هو تداخل عوامل متعددة في تشكيل أزمة الهوية، فمن جهة، تعرض المجتمع العراقي لصدمات سياسية واجتماعية عميقة أدت إلى تفكيك البنى التقليدية للدولة والمجتمع، ومن جهة أخرى، واجه تحديات ما بعد الحداثة التي تنزع نحو تفكيك السرديات الكبرى والهويات الجامعة. وكما يشير زيجمونت باومان في نظريته حول الحداثة السائلة، فإن الهويات في العصر الحديث لم تعد تلك الكيانات الصلبة والثابتة، بل أصبحت سائلة ومتغيرة، تتشكل وتعاد صياغتها باستمرار وفقاً للظروف والسياقات المتغيرة.
في السياق العراقي، تجلت هذه السيولة في تراجع مفهوم الهوية العراقية الجامعة لصالح هويات فرعية متنافسة، سواء كانت طائفية أو عرقية أو قبلية. وهذا التشظي لا يعكس فقط تأثير الأحداث السياسية، بل يعبر أيضاً عن تأثير الخطاب ما بعد الحداثي الذي يُعلي من شأن الخصوصيات الهامشية ويقوض فكرة الانتماء الجماعي الموحد. فالعراقي اليوم يجد نفسه أمام خيارات هوياتية متعددة ومتنافسة، حيث يمكن أن يكون عراقياً شيعياً، سنّيا ، مسيحياً ، عربياً وكرديا في الوقت نفسه، دون أن تكون هناك هرمية واضحة أو تراتبية مستقرة بين هذه الانتماءات.
وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية في تعميق هذا التشظي، حيث أصبحت الهوية تُبنى من خلال التفاعل مع الرموز والعلامات الثقافية التي تنتجها الأنظمة الإعلامية والرقمية. فالشاب العراقي اليوم قد يستمد هويته من مزيج معقد من التراث المحلي والثقافة العالمية، من الموروث الديني والقيم العلمانية، من الانتماء القومي والمواطنة الكونية. وهذا ما يجعل الهوية العراقية المعاصرة كياناً مفتوحاً على معان متداخلة ومتصارعة أحياناً.
من جانب آخر، يحذر عبد الوهاب المسيري من مخاطر الانجراف الكامل وراء منطق ما بعد الحداثة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقافية ومقاومة محاولات الاختزال والتنميط. وفي السياق العراقي، يمكن فهم هذا التحذير كدعوة للبحث عن توازن بين الانفتاح على التعددية الهوياتية من جهة، والحفاظ على الجذور الثقافية والحضارية من جهة أخرى.
إن التحدي الأساسي الذي يواجه العراق اليوم هو كيفية إعادة بناء هوية جامعة تستوعب التنوع الداخلي دون أن تلغيه، وتحافظ على الخصوصية الثقافية دون أن تنغلق على نفسها. وهذا يتطلب إعادة التفكير في مفهوم الهوية العراقية ليس باعتبارها جوهراً ثابتاً، بل كمشروع حضاري مفتوح يتسع للتعددية ويحتفظ في الوقت نفسه بقدرته على إنتاج معنى جماعي مشترك.
وربما تكمن إحدى مزايا ما بعد الحداثة في فتحها المجال أمام إعادة تعريف الهوية العراقية بطريقة أكثر مرونة وشمولية، بحيث تصبح قادرة على استيعاب التنوع الطائفي والعرقي والثقافي الذي يميز المجتمع العراقي. فبدلاً من البحث عن هوية موحدة ومتجانسة، يمكن للعراق أن يطور نموذجاً هوياتياً قائماً على التعددية المتناغمة، حيث تتعايش الهويات الفرعية ضمن إطار وطني جامع.
لكن هذا الاحتمال الإيجابي يبقى مشروطاً بقدرة النخب الثقافية والسياسية العراقية على تطوير خطاب هوياتي جديد يتجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية، ويؤسس لمفهوم المواطنة العراقية على أسس حضارية وثقافية مشتركة. وإلا فإن العراق سيبقى أسير التشظي الهوياتي الذي يهدد وحدته الاجتماعية ويضعف قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
في الختام، تمثل أزمة الهوية العراقية في عصر ما بعد الحداثة تحدياً حضارياً يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية التجربة العراقية وتعقيداتها التاريخية والاجتماعية. فالعراق، بتنوعه الثقافي والديني والعرقي، يمكن أن يكون نموذجاً رائداً في كيفية التعامل مع تحديات الهوية في عالم ما بعد الحداثة، شريطة أن يتمكن من تطوير آليات فعالة للحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين مكوناته المختلفة. وهذا يتطلب جهداً جماعياً من المثقفين والسياسيين والمجتمع المدني لإعادة صياغة الخطاب الهوياتي العراقي بما يخدم مشروع البناء الحضاري والتقدم الإنساني.