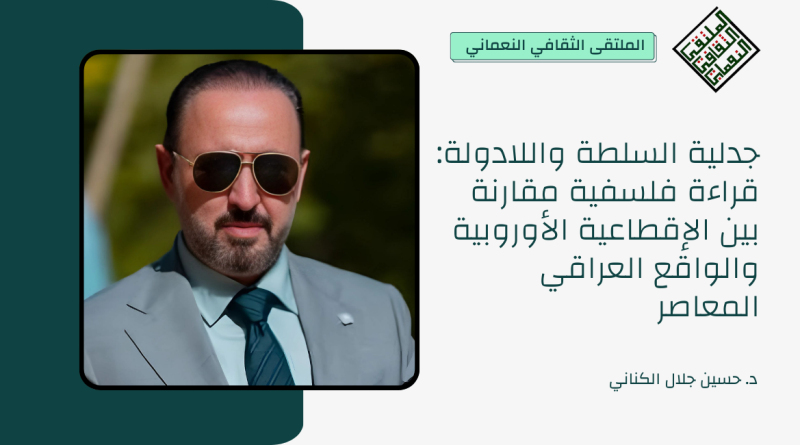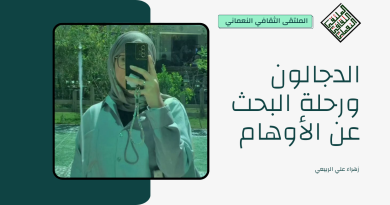جدلية السلطة واللادولة: قراءة فلسفية مقارنة بين الإقطاعية الأوروبية والواقع العراقي المعاصر
د. حسين جلال الكناني
تطرح إشكالية الدولة والسلطة في الفكر السياسي المعاصر تساؤلات جوهرية حول طبيعة الشرعية السياسية ومصادر القوة في المجتمعات الإنسانية. وإذا كان مفهوم الدولة الحديثة قد تبلور عبر قرون من التطور السياسي والفكري، فإن التاريخ يشهد على فترات من التراجع والانحسار لهذا المفهوم، حيث تتشظى السلطة المركزية وتتعدد مراكز القوة، مما يؤدي إلى ظهور ما يمكن تسميته بحالة “اللادولة”. هذه الظاهرة، التي شهدتها أوروبا في العصور الوسطى من خلال النظام الإقطاعي، تتكرر اليوم في العراق بأشكال وآليات مختلفة، لكنها تحمل ذات الخصائص البنيوية والوظيفية التي تميز حالات ضعف السلطة المركزية وتشظي مفهوم السيادة.
إن النظام الإقطاعي الذي ساد أوروبا بين القرنين التاسع والخامس عشر الميلاديين يمثل نموذجاً فريداً لتفكك مفهوم الدولة المركزية وإعادة توزيع السلطة على أسس جغرافية وشخصية. في هذا النظام، لم تعد السيادة مفهوماً موحداً يتجسد في سلطة مركزية واحدة، بل تشظت إلى شبكة معقدة من العلاقات التعاقدية بين الملك والنبلاء، وبين النبلاء والفرسان، وصولاً إلى الفلاحين في قاعدة الهرم الاجتماعي. هذا التشظي لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل كان تعبيراً عن فلسفة سياسية مختلفة تماماً عن مفهوم الدولة الحديثة، حيث تتعدد الولاءات وتتداخل الصلاحيات، ويصبح العنف المشروع موزعاً بين عدة جهات بدلاً من احتكاره من قبل سلطة واحدة.
في هذا السياق، كان النبلاء الإقطاعيون يتمتعون باستقلالية واسعة في إدارة أقاليمهم، حيث يمارسون السلطة القضائية والعسكرية والاقتصادية دون رقابة فعلية من السلطة المركزية. هذه الاستقلالية لم تكن مجرد تفويض إداري، بل كانت تعبيراً عن ضعف جوهري في مفهوم الدولة ذاته، حيث فقدت السلطة المركزية قدرتها على فرض إرادتها على كامل الإقليم، وأصبحت تعتمد على شبكة من التحالفات والولاءات الشخصية للحفاظ على نفوذها. هذا الوضع أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته بـ”أمراء الحرب” في العصور الوسطى، وهم النبلاء الذين تمكنوا من بناء قوة عسكرية واقتصادية مستقلة، مما جعلهم قادرين على تحدي السلطة المركزية أو حتى تجاهلها تماماً. وقد شهدت هذه الفترة أيضاً ظهور ما عُرف بـ”فرسان اللصوص” الذين استغلوا الفراغ الأمني وضعف السلطات المركزية لفرض رسوم غير قانونية وتنفيذ هجمات على القرى والقوافل التجارية، مما يعكس حالة الفوضى التي سادت في ظل غياب سلطة مركزية قوية.
إن هذا النموذج التاريخي يجد صداه المعاصر في الواقع العراقي الحالي، حيث تشهد البلاد منذ عقود حالة من ضعف السلطة المركزية وتشظي مفهوم الدولة. فالعراق اليوم يعيش تحت سيطرة شبكة معقدة من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي يفوق في كثير من الأحيان نفوذ الدولة الرسمية. هذه الفصائل، التي يزيد عددها عن الستين فصيلاً وتضم أكثر من مئة وأربعين ألف مقاتل، تعمل تحت غطاء الدولة لكنها في الواقع تمارس سلطة مستقلة تماماً عن المؤسسات الرسمية. إنها تسيطر على موارد اقتصادية هائلة، وتدير شبكات تجارية واسعة، وتمارس العنف دون رقابة أو محاسبة من السلطات الرسمية، مما يجعلها تشبه إلى حد كبير النبلاء الإقطاعيين في العصور الوسطى.
إن أوجه التشابه بين النموذجين تتجاوز مجرد التشابه الظاهري لتصل إلى البنية العميقة للنظام السياسي. ففي كلا الحالتين، نجد تعدد مراكز القوة وتداخل الولاءات، حيث يصبح المواطن العادي محاطاً بشبكة معقدة من السلطات المتنافسة التي تطالبه بالولاء والطاعة. في العصور الوسطى، كان الفلاح يدين بالولاء لسيده الإقطاعي، والسيد يدين بالولاء للنبيل الأعلى، وهكذا في سلسلة هرمية معقدة. وفي العراق المعاصر، نجد المواطن محاطاً بولاءات متعددة ومتضاربة: للدولة الرسمية، وللفصيل المسلح المهيمن في منطقته، وللمرجعية الدينية، وأحياناً لقوى خارجية تمارس نفوذها من خلال هذه الفصائل. هذا التشابه البنيوي يمتد أيضاً إلى آليات الصراع والتنافس على الموارد، حيث تتحول المنافذ الحدودية والموارد النفطية والمشاريع الاقتصادية الكبرى إلى مصادر قوة تمكن الفصائل من تعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها، تماماً كما كانت الأراضي والموارد الاقتصادية محور الصراع بين النبلاء الإقطاعيين.
ولعل من أبرز أوجه التشابه أيضاً هو الدور المعقد والمتناقض للسلطات الروحية في كلا النموذجين. ففي العصور الوسطى، كانت الكنيسة تلعب دوراً مزدوجاً ومتضارباً، حيث كانت تحاول أحياناً الحد من صراعات النبلاء من خلال ما عُرف بـ”سلام الله” أو “هدنة الله”، بينما كانت في أحيان أخرى تدعم أمراء حرب معينين أو تشرعن عنفهم لخدمة مصالحها السياسية. وفي العراق المعاصر، نجد تعقيداً مشابهاً في دور المرجعيات الدينية.
فالمرجعية العليا في النجف، ممثلة بالسيد السيستاني، قد اتخذت موقفاً واضحاً من خلال دعوتها الشعب العراقي لمحاربة تنظيم داعش تحت مظلة الدولة العراقية، ثم دعوتها اللاحقة لتسليم السلاح للدولة بعد انتهاء المعركة. لكن الفصائل المسلحة رفضت هذه الدعوة وتمسكت بسلاحها، مما خلق تحدياً مباشراً لسلطة المرجعية المحلية. في المقابل، تلعب المرجعيات الخارجية، وخاصة مرجعية ولاية الفقيه في إيران، دوراً مناقضاً تماماً من خلال إضفاء الشرعية الدينية على هذه الفصائل ودعمها مالياً وعسكرياً، مما يذكرنا بدور البابوية أو الكنائس الخارجية في العصور الوسطى التي كانت تدعم أمراء حرب معينين لتحقيق أهدافها السياسية والإقليمية. هذا التناقض بين المرجعيات المحلية والخارجية يعكس تعقيد المشهد الديني والسياسي في العراق، ويوضح كيف يمكن للسلطة الروحية أن تكون أداة لتعزيز الدولة أو تقويضها حسب مصدرها وأهدافها.
لكن الاختلاف الجوهري بين النموذجين يكمن في السياق التاريخي والحضاري. فالنظام الإقطاعي في أوروبا كان نتاجاً طبيعياً لانهيار الإمبراطورية الرومانية وضعف المؤسسات المركزية، وكان يمثل مرحلة انتقالية نحو تشكيل الدول القومية